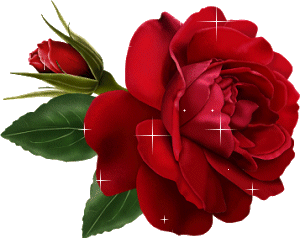كلمات وقيم..
من ذاكرة طفولتي
ثمة لحظات تعود فيها ذاكرتي للوراء، تغرقني في بحر من الصور والألحان، وأتذكر كلمات رافقتنا في طفولتنا، وكونت جزءًا مهمًّا من ذاتنا وفكرنا، غُرِست برقة في أرواحنا، فعلمتنا قيمًا وأخلاقًا وسموا أخاذًا استُمد من عمق ديننا العظيم!
دائما ما تحضرني كلمات من أناشيد الأطفال التي نشأنا معها، ومن أغاني الكرتون التي مكثنا بإصرار أمام شاشة التلفاز لمتابعتها، ولعلَّ ما أتذكره من ألحان ناتج بسبب المعنى الذي باح به اللحن وردده، وما تركه من أثر عجائبي في روحي وفكري! فكم حثتنا على مساعدة الآخرين وتقديم العون:
ساعد غيرك لو تدري ما معنــــى حبُّ الغيرِ
ما أجمل أن تحيا في الأرض بلا نكران
هذا المعنى الإنساني الجميل الذي تبوح به الألحان من مسلسل ماوكلي، يطلب منك ببساطة أن تفهم معنى التعايش مع الآخر ومساعدته، وتفهم قيمة العطاء الذي يورثك السعادة والرقي:
مــــدَّ يديك ولا تتردد فرحي يكبر أصبح أسعد
حين أقدم عونا يومًا تسمو أهدافــــــي تتجدد
فعلا تسمو الأهداف وتتجد عندما نمد يدينا بالعون للآخرين! ولا ريب أن هذا العون مقنن بأصول وأوقات، ويتطلب وعيًّا وحكمة أسرفت الرسوم في تعليمنا إياها!
* * *
حبُّ الوطن، والسعي لخدمته والدفاع عنه، من أجمل المعاني التي عبرت عنها تلك الألحان، ولعل ما يتردد في ذاكرتي غالبا كلمات صقور الأرض، حين يصرِّح بعظمة أن شرف الوطن وعزته أغلى من كل شيء، وأن الإخلاص والفداء واجب علينا:
شرف الوطن أغلى منا ومن
ما قد يجول بفكرنا في أي زمن
شرف الوطن وأرضي
شرف الوطن قبلي وبعدي
شرف الوطن مرآة مجدي
سيفي ورمحي في وجه المحن
تعاهدنا تعاهدنا
تعاهدنا معا على الإخلاص والفداء
تعاهدنا غدا سنعلي راية الجهاد
* * *
الإصرار، والتحدي، والكفاح والمثابرة، من أجمل ما تغنت به تلك الألحان، وتمثلت به أقوالنا بوعي أو بدونه، ثمة تأثر ملموس يجول في أعماقنا، يجعلنا نتحلى تلقائيا بهذه الصفات، ويعجبني ما جاء في مسلسل أرغاي:
فلتمضِ بعزم وإرادة فالشر ضعيف
هيا بعقول وقـــــادة لا شيء يخيف
والحق مصـــــان فامضِ بأمـــــان
جميل جدا هذا التعبير البسيط عن واقع متحقق لا محالة، العزم والإرادة بصحبة العقل الفطن كفيل بدحر الظلم، فمهما حدث يبقى الحق مصان عند الخالق الكريم. وغالبا يقترن ذكره هذه الصفات من عزم وإرادة عند صراع الخير والشر وحتمية النهاية الخيرة، وأذكر من حكايات ما أحلاها قولهم:
الخير في الأرض سيبقى محفوظا للأوفياء
في مقابل قولهم:
والشر يبقى في المغيب
وبالرجوع للحديث عن روح الإصرار والتحدي أذكر كلمات السباق الكبير وهو يقول:
للأفق خط واسع مع المدى يدوم
للأفق درب واحد ولنا دروب
وتتجلى في عبارة: ولنا دروب، معانٍ واسعة وطموحة وأحلام تعانق السحاب:
فلننطلق معا نوحد الدروب
ونمضي للأمام للأمام
هيا فلندخل المضمار
بعزمنا نسابق الإعصار
الرغبة في توحيد الهدف، السعي بعزيمة نحوه وبقوة تأبى الانحناء أو التوقف، قيم جميلة والأجمل طرحها بصور تعبيرية لطيفة تجعل منها أكثر ملامسة للفكر وتنبيهًا له، وأكثر واقعية كذلك، هذه الجمالية تجعل مثل هذه الكلمات والعبر أكثر قبولا من العبارات المباشرة التي لا تعدو كونها كلمات فقدت المعنى من كثرة التكرار!!
* * *
الصبر والاهتمام بالآخرين، مقاومة اليأس، أستحضر معها كلمات أنا وأخي:
لو سرقت منا الأيام قلبا معطاء بسام
لن نستسلم للآلام لن نستسلم للآلام
وفي ظل هذا الألم:
لا تنسَ أخاك
ترعاه يداك
وأتذكر كذلك كلمات عهد الأصدقاء، وصديقنا منظف المداخن روميو، وأصدقاؤه، وعهدهم الوفي:
وتبقينا الحياة أضواء لآخر النهار
فدعونا.. كي ننسى ألما عشناه
نستسلم؟ لكن لا ما دمنا أحياء نرزق
ما دام الأمل طريقا فسنحياه
فعلا ما دام الأمل طريقا فسنحياه!
* * *
تذكرون مسلسل بابار؟! ما أحبه هذه الكلمات فيه:
برفق قال لنـــــــــا ليس هنالك ما يخيف
نحن الخير بطبعنـا لا نرضَ ظلم الضعيف
لا يحيا بيننــــــــــا إلا الإنســان الشريف
رفض الظلم للضعيف بمختلف أنواعه، السعي نحو النموذج الأمثل للإنسان الشريف، وبالرغم من اختلاف الواقع واستحالة اصطفاء الناس، فهذا الحلم ـ بوجود المجتمع الشريف الخالي من الشر ـ في حد ذاته حلم له جماليته وروحانيته الخاصة.
بالأخلاق الفاضلــة بالمحبــــــة بالأمــل
نسمــو ننتصر على المصاعب في العمل
بــــادروا دوما إلى الاعتـــــراف بالزلل
لا ترفضـــوا خجلا ضحكنـــــا قلنا أجل
كيف نتغلب على المصاعب في الحياة وأعمالها الجماعية؟ بالأخلاق الفاضلة وأهمها الاعتراف بالزلل والخطأ وتصحيحه، وليس تجاهله أو تجاوزه بالدعوى أننا نبتعد عن لوم بعضنا بعض! فصاحب الخطأ يجب أن يتحلى بالشجاعة ويعترف به ويحَاسب! لأنه لو تم تجاهله فسيتكرر مرارا، وهذا ليس من صفات المجتمع الشريف!
* * *
الحديث يطول ويطول والعبر الطيبة لا تنتهي والقيم النبيلة نور ينبغي أن يتشربه الصغار، واختم حديثي بكلمات رائعة جدا جدا جدا في بساطتها وعمقها وفصاحتها، كانت لمسلسل عرض برمضان قبل سنوات، لا أذكره لكن كلماته تعجبني بشدة وبفرح أتركها تجول بخاطري:
من كـــــان ينظر للبعيد يبدي لنا الرأي السديدْ
ما خـــــاب في قول ولا أبدى لنـــــــا إلا المفيدْ
لا عيـــــش إلا بالأمــــل مهما يكن نوع العمــلْ
من سار في الدرب وصل يختــــال في ثوب جديدْ
هــذي المظـــاهر بالية من كــــــل حسن خاليةْ
والصالحــــــــات الباقية تهدي لنا العيش الرغيدْ
رسوم اليوم مضمونها وكلماتها مفسدة لعقل الطفل لا معنى ولا فكرة ولا عبر إلا ما ندر! أنى لنا بكلمات بسيطة تحفل بكل هذه الحكم، وموجهة للطفل أولا؟ ختام القول: والصالحات الباقية تهدي لنا العيش الرغيد: سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.